[ ص: 115 ] النوع الأول
معرفة أسباب النزول
وقد اعتنى بذلك المفسرون في كتبهم ، وأفردوا فيه تصانيف ; منهم علي بن المديني شيخ البخاري ، ومن أشهرها تصنيف الواحدي في ذلك .
[ ص: 116 ] وأخطأ من زعم أنه لا طائل تحته لجريانه مجرى التاريخ ، وليس كذلك ، بل له [ ص: 117 ] فوائد :
منها وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم .
ومنها تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب .
ومنها الوقوف على المعنى ، قال الشيخ أبو الفتح القشيري : " بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز " ، وهو أمر تحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا .
ومنها أنه قد يكون اللفظ عاما ، ويقوم الدليل على التخصيص ، فإن محل السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد بالإجماع كما حكاه القاضي أبو بكر في " مختصر التقريب " ; لأن دخول السبب قطعي .
ونقل بعضهم الاتفاق على أن لتقدم السبب على ورود العموم أثرا .
ولا التفات إلى ما نقل عن بعضهم من تجويز إخراج محل السبب بالتخصيص لأمرين :
أحدهما : أنه يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولا يجوز . والثاني : أن فيه عدولا عن محل السؤال ; وذلك لا يجوز في حق الشارع ; لئلا يلتبس على السائل . واتفقوا على أنه تعتبر النصوصية في السبب من جهة استحالة تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وتؤثر أيضا فيما وراء محل السبب ، وهو إبطال الدلالة على قول ، والضعف على قول .
ومن الفوائد أيضا دفع توهم الحصر ، قال الشافعي ما معناه في معنى قوله تعالى : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ) ( الأنعام : 145 ) الآية : إن الكفار لما حرموا ما أحل [ ص: 118 ] الله ، وأحلوا ما حرم الله ، وكانوا على المضادة والمحادة فجاءت الآية مناقضة لغرضهم ، فكأنه قال : لا حلال إلا ما حرمتموه ، ولا حرام إلا ما أحللتموه ، نازلا منزلة من يقول : لا تأكل اليوم حلاوة ، فتقول : لا آكل اليوم إلا الحلاوة ، والغرض المضادة لا النفي والإثبات على الحقيقة ، فكأنه قال : لا حرام إلا ما حللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ، ولم يقصد حل ما وراءه ، إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل .
قال إمام الحرمين : " وهذا في غاية الحسن ، ولولا سبق الشافعي إلى ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك في حصر المحرمات فيما ذكرته الآية . وهذا قد يكون من الشافعي أجراه مجرى التأويل " . ومن قال بمراعاة اللفظ دون سببه لا يمنع من التأويل .
وقد جاءت آيات في مواضع اتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها ; كنزول آية الظهار في سلمة بن صخر وآية اللعان في شأن هلال بن أمية ، . . . . . . . . ونزول حد [ ص: 119 ] القذف في رماة عائشة - رضي الله عنها - ثم تعدى إلى غيرهم ، وإن كان قد قال سبحانه : ( والذين يرمون المحصنات ) ( النور : 4 ) ، فجمعها مع غيرها ، إما تعظيما لها إذ أنها أم المؤمنين - ومن رمى أم قوم فقد رماهم - وإما للإشارة إلى التعميم ، ولكن الرماة لها كانوا معلومين ، فتعدى الحكم إلى من سواهم ، فمن يقول بمراعاة حكم اللفظ كان الاتفاق هاهنا هو مقتضى الأصل ، ومن قال بالقصر على الأصل خرج عن الأصل في هذه الآية بدليل . ونظير هذا تخصيص الاستعاذة بالإناث في قوله تعالى : ( ومن شر النفاثات في العقد ) ( الفلق : 4 ) لخروجه على السبب ; وهو أن بنات لبيد سحرن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
كذا قال أبو عبيد : وفيه نظر ، فإن الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم هو لبيد بن الأعصم كما جاء في الصحيح .
وقد تنزل الآيات على الأسباب خاصة ، وتوضع كل واحدة منها مع ما يناسبها من الآي رعاية لنظم القرآن وحسن السياق ، فذلك الذي وضعت معه الآية نازلة على سبب خاص للمناسبة ; إذ كان مسوقا لما نزل في معنى يدخل تحت ذلك اللفظ العام ، أو كان من جملة [ ص: 120 ] الأفراد الداخلة وضعا تحت اللفظ العام ، فدلالة اللفظ عليه : هل هي كالسبب ، فلا يخرج ويكون مرادا من الآيات قطعا ؟ أو لا ينتهي في القراءة إلى ذلك ; لأنه قد يراد غيره ، وتكون المناسبة مشبهة به ؟ فيه احتمال .
واختار بعضهم أنه رتبة متوسطة دون السبب وفوق العام المجرد ، ومثاله قوله تعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) ( النساء : 58 ) فإن مناسبتها للآية التي قبلها ، وهي قوله تعالى : ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ) ( النساء : 51 ) أن ذلك إشارة إلى كعب بن الأشرف ، كان قدم إلى مكة وشاهد قتلى بدر وحرض الكفار على الأخذ بثأرهم وغزو النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه من أهدى سبيلا ؟ النبي صلى الله عليه وسلم أو هم ؟ فقال : أنتم - كذبا منه وضلالة - لعنه الله ! فتلك الآية في حقه وحق من شاركه في تلك المقالة ، وهم أهل كتاب يجدون عندهم في كتابهم نعت النبي صلى الله عليه وسلم وصفته ، وقد أخذت عليهم المواثيق ألا يكتموا ذلك وأن ينصروه ، وكان ذلك أمانة لازمة لهم ، فلم يؤدوها ، وخانوا فيها ، وذلك مناسب لقوله : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) ( النساء : 58 ) قال ابن العربي في " تفسيره " : " وجه النظم أنه أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد صلى الله عليه وسلم ، وقولهم : إن المشركين أهدى سبيلا ، فكان ذلك خيانة منهم ، فانجر الكلام إلى ذكر جميع الأمانات " انتهى .
ولا يرد على هذا أن قصة كعب بن الأشرف كانت عقب بدر ، ونزول ( إن الله يأمركم ) ( النساء : 58 ) في الفتح أو قريبا منها وبينهما ست سنين ; لأن الزمان إنما يشترط [ ص: 121 ] في سبب النزول ولا يشترط في المناسبة لأن المقصود منها وضع آية في موضع يناسبها ، والآيات كانت تنزل على أسبابها ، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعها في المواضع التي علم من الله تعالى أنها مواضعها .
ومن فوائد هذا العلم إزالة الإشكال ، ففي " الصحيح " عن مروان بن الحكم : " أنه بعث إلى ابن عباس يسأله : لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا ، لنعذبن أجمعون ، فقال ابن عباس : هذه الآية نزلت في أهل الكتاب ، ثم تلا : ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ) ( آل عمران : 187 ) إلى قوله : ( لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ) ( آل عمران : 188 ) .
قال ابن عباس : سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره ، فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه ، فاستحمدوا بذلك إليه ، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم ما سألهم عنه " . انتهى .
قال بعضهم : وما أجاب به ابن عباس عن سؤال مروان لا يكفي ; لأن اللفظ أعم من السبب ، ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم : المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور وإنما الجواب أن الوعيد مرتب على أثر الأمرين المذكورين ، وهما الفرح وحب الحمد ، لا عليهما أنفسهما ; إذ هما من الأمور الطبيعية التي لا يتعلق بها التكليف أمرا ولا نهيا .
قلت : لا يخفى عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن اللفظ أعم من السبب ; لكنه [ ص: 122 ] بين أن المراد باللفظ خاص ونظيره تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بالشرك فيما سبق .
ومن ذلك قوله تعالى : ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) ( المائدة : 93 ) الآية ، فـ " حكي عن عثمان بن مظعون وعمرو بن معد يكرب أنهما كانا يقولان : الخمر مباحة ، ويحتجان بهذه الآية ، وخفي عليها سبب نزولها ; فإنه يمنع من ذلك ، وهو ما قاله الحسن وغيره : لما نزل تحريم الخمر قالوا : كيف بإخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم . وقد أخبر الله أنها رجس ، فأنزل الله تعالى : ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح ) ( المائدة : 93 ) .
ومن ذلك قوله تعالى : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم ) ( الطلاق : 4 ) الآية ، قد أشكل معنى هذا الشرط على بعض الأئمة ، وقد بينه سبب النزول ، روي " أن ناسا قالوا : يا رسول الله ، قد عرفنا عدة ذوات الأقراء ، فما عدة اللائي لم يحضن من الصغار والكبار ؟ فنزلت ، فهذا يبين معنى : ( إن ارتبتم ) ( الطلاق : 4 ) أي إن أشكل عليكم حكمهن وجهلتم كيف يعتددن فهذا حكمهن " .
[ ص: 123 ] ومن ذلك قوله تعالى : ( ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ) ( البقرة : 115 ) فإنا لو تركنا مدلول اللفظ لاقتضى أن المصلي لا يجب عليه استقبال القبلة سفرا ولا حضرا ، وهو خلاف الإجماع ، فلا يفهم مراد الآية حتى يعلم سببها ، وذلك " أنها نزلت لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وهو مستقبل من مكة إلى المدينة حيث توجهت به " فعلم أن هذا هو المراد .
ومن ذلك قوله تعالى : ( إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم ) ( التغابن : 14 ) فإن سبب نزولها : " أن قوما أرادوا الخروج للجهاد ، فمنعهم أزواجهم وأولادهم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ثم أنزل في بقيتها ما يدل على الرحمة وترك المؤاخذة ، فقال : ( وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم ) ( التغابن : 14 ) " .
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
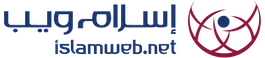
 المكتبة الإسلامية
المكتبة الإسلامية موسوعة التربية
موسوعة التربية كتاب الأمة
كتاب الأمة حول المكتبة
حول المكتبة قائمة الكتب
قائمة الكتب عرض موضوعي
عرض موضوعي تراجم الأعلام
تراجم الأعلام














 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات