[ ص: 204 ] كتاب السير
هي جمع سيرة ، وهي الطريقة ، والمقصود : الكلام في الجهاد وأحكامه وفيه ثلاثة أبواب : الأول : في وجوب الجهاد ، وبيان فروض الكفايات ، وفيه أطراف .
الأول : في مختصر يتعلق بابتداء الأمر بالجهاد وغيره ، قال الشافعي والأصحاب - رحمهم الله - : لما بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالتبليغ والإنذار بلا قتال ، واتبعه قوم بعد قوم ، وفرضت الصلاة بمكة ، ثم فرض الصوم بعد الهجرة بسنتين ، واختلفوا في أن الزكاة فرضت بعد الصوم أم قبله ، ثم فرض الحج سنة ست ، وقيل : سنة خمس ، وكان القتال ممنوعا منه في أول الإسلام وأمروا بالصبر على أذى الكفار ، فلما هاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة ، وجبت الهجرة على من قدر ، فلما فتحت مكة ، ارتفعت الهجرة منها إلى المدينة ، ونفي وجوب الهجرة من دار الحرب على ما سنذكره - إن شاء الله تعالى - ثم أذن الله سبحانه وتعالى في القتال للمسلمين إذا ابتدأهم الكفار بقتال ، ثم أباح القتال ابتداء ، لكن في غير الأشهر الحرم ، ثم أمر به من غير تقييد بشرط ولا زمان ، ولم يعبد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صنما قط قال صاحب " البيان " : كان متمسكا قبل النبوة بدين إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - .
قلت : تعرض الرافعي - رحمه الله - لهذه النبذ ، ولم يذكر فيها ما يليق به ولا بهذا الكتاب ، وأنا أشير إلى أصول مقاصدها بألفاظ وجيزة - إن [ ص: 205 ] شاء الله تعالى - . اتفقوا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعبد صنما قط ، والأنبياء قبل النبوة معصومون من الكفر ، واختلفوا في العصمة من المعاصي ، وأما بعد النبوة فمعصومون من الكفر ، ومن كل ما يخل بالتبليغ ، وما يزري بالمروءة ، ومن الكبائر ، واختلفوا في الصغائر فجوزها الأكثرون ، ومنعها المحققون وقطعوا بالعصمة منها ، وتأولوا الظواهر الواردة فيها ، واختلفوا في أن نبينا - صلى الله عليه وسلم - هل كان قبل النبوة يتعبد على دين نوح وإبراهيم أم موسى أم عيسى ، أم يتعبد لا ملتزما دين واحد من المذكورين ، والمختار أنه لا يجزم في ذلك بشيء ، إذ ليس فيه دلالة على عقل ولا ثبت فيه نص ولا إجماع ، واختلف أصحابنا في شرع من قبلنا ، هل هو شرع لنا إذا لم يرد شرعنا بنسخ ذلك الحكم ؟ والأصح أنه ليس بشرع لنا ، وقيل : بلى ، وقيل : شرع إبراهيم فقط ؛ وبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وله أربعون سنة ، وقيل : أربعون ويوم ، فأقام في مكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة ، وقيل : عشرا ، وقيل : خمس عشرة ، والصحيح الأول ، ثم هاجر إلى المدينة ، فأقام بها عشرا بالإجماع ، ودخلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضحى يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول ، وتوفي - صلى الله عليه وسلم - ضحى يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة ؛ ومنها ابتداء التاريخ ، ودفن ليلة الأربعاء ، وقيل : ليلة الثلاثاء ، ومدة مرضه - صلى الله عليه وسلم - الذي توفي فيه اثنا عشر يوما ، وقيل : أربعة عشر ، وغسله علي والعباس والفضل وقثم وأسامة وشقران - رضي الله عنهم - ، وكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة ، وصلى عليه المسلمون أفرادا ، بلا إمام ، ودخل قبره علي والعباس والفضل وقثم وشقران ، ودفن في اللحد وجعل فيه تسع لبنات ، ودفن في الموضع الذي توفي فيه ، وهو [ ص: 206 ] حجرة عائشة ، ثم دفن عنده أبو بكر ، ثم عمر - رضي الله عنهما - ولم يحج - صلى الله عليه وسلم - بعد الهجرة إلا حجة الوداع سنة عشر ، وسميت حجة الوداع ؛ لأنه ودع الناس فيها - صلى الله عليه وسلم - ، واعتمر - صلى الله عليه وسلم - أربع عمر ، واختلفوا هل فرض الحج سنة ست أو خمس أو تسع ، وأول ما وجب الإنذار والدعاء إلى التوحيد ، ثم فرض الله تعالى من قيام الليل ما ذكره في أول سورة المزمل ، ثم نسخه بما في أواخرها ، ثم نسخه بإيجاب الصلوات الخمس ليلة الإسراء بمكة بعد النبوة بعشر سنين وثلاثة أشهر ليلة سبع وعشرين من رجب ، وكان - صلى الله عليه وسلم - مأمورا بالصلاة إلى بيت المقدس مدة مقامه بمكة وبعد الهجرة ستة عشر شهرا أو سبعة عشر ، ثم أمره الله تعالى باستقبال الكعبة .
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية

روضة الطالبين وعمدة المفتين
النووي - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
- روضة الطالبين وعمدة المفتين
- كتاب السير
- الباب الأول في وجوب الجهاد
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528
- 529
- 530
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- 540
- 541
- 542
- 543
- 544
- 545
- 546
- 547
- 548
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- 554
- 555
- 556
- 557
- 558
- 559
- 560
- 561
- 562
- 563
- 564
- 565
- 566
- 567
- 568
- 569
- 570
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- 585
- 586
- 587
- 588
- 589
الطرف الأول في مختصر يتعلق بابتداء الأمر بالجهاد
 صفحة
204
صفحة
204
 جزء
10
جزء
10
[ ص: 204 ] كِتَابُ السِّيَرِ
هِيَ جَمْعُ سِيرَةٍ ، وَهِيَ الطَّرِيقَةُ ، وَالْمَقْصُودُ : الْكَلَامُ فِي الْجِهَادِ وَأَحْكَامُهُ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَبْوَابٍ : الْأَوَّلُ : فِي وُجُوبِ الْجِهَادِ ، وَبَيَانِ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ ، وَفِيهِ أَطْرَافٌ .
الْأَوَّلُ : فِي مُخْتَصَرٍ يَتَعَلَّقُ nindex.php?page=treesubj&link=7860بِابْتِدَاءِ الْأَمْرِ بِالْجِهَادِ وَغَيْرِهِ ، قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - : لَمَّا بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُمِرَ بِالتَّبْلِيغِ وَالْإِنْذَارِ بِلَا قِتَالٍ ، وَاتَّبَعَهُ قَوْمٌ بَعْدَ قَوْمٍ ، وَفُرِضَتِ الصَّلَاةُ بِمَكَّةَ ، ثُمَّ فُرِضَ الصَّوْمُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ بِسَنَتَيْنِ ، nindex.php?page=treesubj&link=23844وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الزَّكَاةَ فُرِضَتْ بَعْدَ الصَّوْمِ أَمْ قَبْلَهُ ، ثُمَّ فُرِضَ الْحَجُّ سَنَةَ سِتٍّ ، وَقِيلَ : سَنَةَ خَمْسٍ ، وَكَانَ الْقِتَالُ مَمْنُوعًا مِنْهُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَأُمِرُوا بِالصَّبْرِ عَلَى أَذَى الْكُفَّارِ ، فَلَمَّا هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَجَبَتِ الْهِجْرَةُ عَلَى مَنْ قَدَرَ ، فَلَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ ، ارْتَفَعَتِ الْهِجْرَةُ مِنْهَا إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَنُفِي وُجُوبُ الْهِجْرَةِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - ثُمَّ أَذِنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الْقِتَالِ لِلْمُسْلِمِينَ إِذَا ابْتَدَأَهُمُ الْكُفَّارُ بِقِتَالٍ ، ثُمَّ أَبَاحَ الْقِتَالَ ابْتِدَاءً ، لَكِنْ فِي غَيْرِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِشَرْطٍ وَلَا زَمَانٍ ، وَلَمْ يَعْبُدْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَنَمًا قَطُّ قَالَ صَاحِبُ " الْبَيَانِ " : كَانَ مُتَمَسِّكًا قَبْلَ النُّبُوَّةِ بِدِينِ إِبْرَاهِيمَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
قُلْتُ : تَعَرَّضَ الرَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِهَذِهِ النُّبَذِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهَا مَا يَلِيقُ بِهِ وَلَا بِهَذَا الْكِتَابِ ، وَأَنَا أُشِيرُ إِلَى أُصُولِ مَقَاصِدِهَا بِأَلْفَاظٍ وَجِيزَةٍ - إِنْ [ ص: 205 ] شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - . اتَّفَقُوا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - nindex.php?page=treesubj&link=29262لَمْ يَعْبُدْ صَنَمًا قَطُّ ، nindex.php?page=treesubj&link=28751وَالْأَنْبِيَاءُ قَبْلَ النُّبُوَّةِ مَعْصُومُونَ مِنَ الْكُفْرِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْعِصْمَةِ مِنَ الْمَعَاصِي ، وَأَمَّا بَعْدُ النُّبُوَّةِ فَمَعْصُومُونَ مِنَ الْكُفْرِ ، وَمِنْ كُلِّ مَا يُخِلُّ بِالتَّبْلِيغِ ، وَمَا يُزْرِي بِالْمُرُوءَةِ ، وَمِنَ الْكَبَائِرِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّغَائِرِ فَجَوَّزَهَا الْأَكْثَرُونَ ، وَمَنَعَهَا الْمُحَقِّقُونَ وَقَطَعُوا بِالْعِصْمَةِ مِنْهَا ، وَتَأَوَلُوا الظَّوَاهِرَ الْوَارِدَةَ فِيهَا ، وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّ نَبِيَّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - nindex.php?page=treesubj&link=29262هَلْ كَانَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ يَتَعَبَّدُ عَلَى دِينِ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ أَمْ مُوسَى أَمْ عِيسَى ، أَمْ يَتَعَبَّدُ لَا مُلْتَزِمًا دِينٍ وَاحِدٍ مِنَ الْمَذْكُورِينَ ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يُجْزَمُ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ ، إِذْ لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى عَقْلٍ وَلَا ثَبَتَ فِيهِ نَصٌّ وَلَا إِجْمَاعٌ ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي nindex.php?page=treesubj&link=22123شَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا ، هَلْ هُوَ شَرْعٌ لَنَا إِذَا لَمْ يَرِدْ شَرْعُنَا بِنَسْخِ ذَلِكَ الْحُكْمِ ؟ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْعٍ لَنَا ، وَقِيلَ : بَلَى ، وَقِيلَ : شَرْعُ إِبْرَاهِيمَ فَقَطْ ؛ nindex.php?page=treesubj&link=29274وَبُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَهُ أَرْبَعُونَ سَنَةً ، وَقِيلَ : أَرْبَعُونَ وَيَوْمٌ ، nindex.php?page=treesubj&link=29273فَأَقَامَ فِي مَكَّةَ بَعْدَ النُّبُوَّةِ ثَلَاثَ عَشَرَةَ سَنَةً ، وَقِيلَ : عَشْرًا ، وَقِيلَ : خَمْسَ عَشَرَةَ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ، ثُمَّ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَأَقَامَ بِهَا عَشْرًا بِالْإِجْمَاعِ ، وَدَخْلَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضُحَى يَوْمِ الِاثْنَيْنِ لِاثْنَتَيْ عَشَرَةَ خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ ، وَتُوُفِّيَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضُحَى يَوْمِ الِاثْنَيْنِ لِاثْنَتَيْ عَشَرَةَ خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ إِحْدَى عَشَرَةَ مِنَ الْهِجْرَةِ ؛ وَمِنْهَا ابْتِدَاءُ التَّارِيخِ ، وَدُفِنَ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ ، وَقِيلَ : لَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ ، nindex.php?page=treesubj&link=29394وَمُدَّةُ مَرَضِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ اثْنَا عَشَرَ يَوْمًا ، وَقِيلَ : أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، وَغَسَّلَهُ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ وَالْفَضْلُ وَقُثَمٌ وَأُسَامَةُ وَشُقْرَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ، nindex.php?page=treesubj&link=29394وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ ، وَصَلَّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ أَفْرَادًا ، بِلَا إِمَامٍ ، وَدَخَلَ قَبْرَهُ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ وَالْفَضْلُ وَقُثَمٌ وَشُقْرَانُ ، وَدُفِنَ فِي اللَّحْدِ وَجُعِلَ فِيهِ تِسْعُ لَبِنَاتٍ ، وَدُفِنَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ ، وَهُوَ [ ص: 206 ] حُجْرَةُ عَائِشَةَ ، ثُمَّ دُفِنَ عِنْدَهُ أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَلَمْ يَحُجَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ الْهِجْرَةِ إِلَّا حَجَّةَ الْوَدَاعِ سَنَةَ عَشْرٍ ، وَسُمِّيَتْ حَجَّةَ الْوَدَاعِ ؛ لِأَنَّهُ وَدَّعَ النَّاسَ فِيهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، nindex.php?page=treesubj&link=33051وَاعْتَمَرَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعَ عُمَرٍ ، وَاخْتَلَفُوا هَلْ فُرِضَ الْحَجُّ سَنَةَ سِتٍّ أَوْ خَمْسٍ أَوْ تِسْعٍ ، وَأَوَّلُ مَا وَجَبَ الْإِنْذَارُ وَالدُّعَاءُ إِلَى التَّوْحِيدِ ، ثُمَّ فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ مَا ذَكَرَهُ فِي أَوَّلِ سُورَةِ الْمُزَّمِّلِ ، ثُمَّ نَسَخَهُ بِمَا فِي أَوَاخِرِهَا ، ثُمَّ نَسَخَهُ بِإِيجَابِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ بِمَكَّةَ بَعْدَ النُّبُوَّةِ بِعَشْرِ سِنِينَ وَثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ ، وَكَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَأْمُورًا بِالصَّلَاةِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ مُدَّةَ مَقَامِهِ بِمَكَّةَ وَبَعْدَ الْهِجْرَةِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ .
هِيَ جَمْعُ سِيرَةٍ ، وَهِيَ الطَّرِيقَةُ ، وَالْمَقْصُودُ : الْكَلَامُ فِي الْجِهَادِ وَأَحْكَامُهُ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَبْوَابٍ : الْأَوَّلُ : فِي وُجُوبِ الْجِهَادِ ، وَبَيَانِ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ ، وَفِيهِ أَطْرَافٌ .
الْأَوَّلُ : فِي مُخْتَصَرٍ يَتَعَلَّقُ nindex.php?page=treesubj&link=7860بِابْتِدَاءِ الْأَمْرِ بِالْجِهَادِ وَغَيْرِهِ ، قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - : لَمَّا بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُمِرَ بِالتَّبْلِيغِ وَالْإِنْذَارِ بِلَا قِتَالٍ ، وَاتَّبَعَهُ قَوْمٌ بَعْدَ قَوْمٍ ، وَفُرِضَتِ الصَّلَاةُ بِمَكَّةَ ، ثُمَّ فُرِضَ الصَّوْمُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ بِسَنَتَيْنِ ، nindex.php?page=treesubj&link=23844وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الزَّكَاةَ فُرِضَتْ بَعْدَ الصَّوْمِ أَمْ قَبْلَهُ ، ثُمَّ فُرِضَ الْحَجُّ سَنَةَ سِتٍّ ، وَقِيلَ : سَنَةَ خَمْسٍ ، وَكَانَ الْقِتَالُ مَمْنُوعًا مِنْهُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَأُمِرُوا بِالصَّبْرِ عَلَى أَذَى الْكُفَّارِ ، فَلَمَّا هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَجَبَتِ الْهِجْرَةُ عَلَى مَنْ قَدَرَ ، فَلَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ ، ارْتَفَعَتِ الْهِجْرَةُ مِنْهَا إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَنُفِي وُجُوبُ الْهِجْرَةِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - ثُمَّ أَذِنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الْقِتَالِ لِلْمُسْلِمِينَ إِذَا ابْتَدَأَهُمُ الْكُفَّارُ بِقِتَالٍ ، ثُمَّ أَبَاحَ الْقِتَالَ ابْتِدَاءً ، لَكِنْ فِي غَيْرِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِشَرْطٍ وَلَا زَمَانٍ ، وَلَمْ يَعْبُدْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَنَمًا قَطُّ قَالَ صَاحِبُ " الْبَيَانِ " : كَانَ مُتَمَسِّكًا قَبْلَ النُّبُوَّةِ بِدِينِ إِبْرَاهِيمَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
قُلْتُ : تَعَرَّضَ الرَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِهَذِهِ النُّبَذِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهَا مَا يَلِيقُ بِهِ وَلَا بِهَذَا الْكِتَابِ ، وَأَنَا أُشِيرُ إِلَى أُصُولِ مَقَاصِدِهَا بِأَلْفَاظٍ وَجِيزَةٍ - إِنْ [ ص: 205 ] شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - . اتَّفَقُوا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - nindex.php?page=treesubj&link=29262لَمْ يَعْبُدْ صَنَمًا قَطُّ ، nindex.php?page=treesubj&link=28751وَالْأَنْبِيَاءُ قَبْلَ النُّبُوَّةِ مَعْصُومُونَ مِنَ الْكُفْرِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْعِصْمَةِ مِنَ الْمَعَاصِي ، وَأَمَّا بَعْدُ النُّبُوَّةِ فَمَعْصُومُونَ مِنَ الْكُفْرِ ، وَمِنْ كُلِّ مَا يُخِلُّ بِالتَّبْلِيغِ ، وَمَا يُزْرِي بِالْمُرُوءَةِ ، وَمِنَ الْكَبَائِرِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي الصَّغَائِرِ فَجَوَّزَهَا الْأَكْثَرُونَ ، وَمَنَعَهَا الْمُحَقِّقُونَ وَقَطَعُوا بِالْعِصْمَةِ مِنْهَا ، وَتَأَوَلُوا الظَّوَاهِرَ الْوَارِدَةَ فِيهَا ، وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّ نَبِيَّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - nindex.php?page=treesubj&link=29262هَلْ كَانَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ يَتَعَبَّدُ عَلَى دِينِ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ أَمْ مُوسَى أَمْ عِيسَى ، أَمْ يَتَعَبَّدُ لَا مُلْتَزِمًا دِينٍ وَاحِدٍ مِنَ الْمَذْكُورِينَ ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يُجْزَمُ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ ، إِذْ لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى عَقْلٍ وَلَا ثَبَتَ فِيهِ نَصٌّ وَلَا إِجْمَاعٌ ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي nindex.php?page=treesubj&link=22123شَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا ، هَلْ هُوَ شَرْعٌ لَنَا إِذَا لَمْ يَرِدْ شَرْعُنَا بِنَسْخِ ذَلِكَ الْحُكْمِ ؟ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْعٍ لَنَا ، وَقِيلَ : بَلَى ، وَقِيلَ : شَرْعُ إِبْرَاهِيمَ فَقَطْ ؛ nindex.php?page=treesubj&link=29274وَبُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَهُ أَرْبَعُونَ سَنَةً ، وَقِيلَ : أَرْبَعُونَ وَيَوْمٌ ، nindex.php?page=treesubj&link=29273فَأَقَامَ فِي مَكَّةَ بَعْدَ النُّبُوَّةِ ثَلَاثَ عَشَرَةَ سَنَةً ، وَقِيلَ : عَشْرًا ، وَقِيلَ : خَمْسَ عَشَرَةَ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ، ثُمَّ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَأَقَامَ بِهَا عَشْرًا بِالْإِجْمَاعِ ، وَدَخْلَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضُحَى يَوْمِ الِاثْنَيْنِ لِاثْنَتَيْ عَشَرَةَ خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ ، وَتُوُفِّيَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضُحَى يَوْمِ الِاثْنَيْنِ لِاثْنَتَيْ عَشَرَةَ خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ إِحْدَى عَشَرَةَ مِنَ الْهِجْرَةِ ؛ وَمِنْهَا ابْتِدَاءُ التَّارِيخِ ، وَدُفِنَ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ ، وَقِيلَ : لَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ ، nindex.php?page=treesubj&link=29394وَمُدَّةُ مَرَضِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ اثْنَا عَشَرَ يَوْمًا ، وَقِيلَ : أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، وَغَسَّلَهُ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ وَالْفَضْلُ وَقُثَمٌ وَأُسَامَةُ وَشُقْرَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ، nindex.php?page=treesubj&link=29394وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ ، وَصَلَّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ أَفْرَادًا ، بِلَا إِمَامٍ ، وَدَخَلَ قَبْرَهُ عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ وَالْفَضْلُ وَقُثَمٌ وَشُقْرَانُ ، وَدُفِنَ فِي اللَّحْدِ وَجُعِلَ فِيهِ تِسْعُ لَبِنَاتٍ ، وَدُفِنَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ ، وَهُوَ [ ص: 206 ] حُجْرَةُ عَائِشَةَ ، ثُمَّ دُفِنَ عِنْدَهُ أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَلَمْ يَحُجَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ الْهِجْرَةِ إِلَّا حَجَّةَ الْوَدَاعِ سَنَةَ عَشْرٍ ، وَسُمِّيَتْ حَجَّةَ الْوَدَاعِ ؛ لِأَنَّهُ وَدَّعَ النَّاسَ فِيهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، nindex.php?page=treesubj&link=33051وَاعْتَمَرَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعَ عُمَرٍ ، وَاخْتَلَفُوا هَلْ فُرِضَ الْحَجُّ سَنَةَ سِتٍّ أَوْ خَمْسٍ أَوْ تِسْعٍ ، وَأَوَّلُ مَا وَجَبَ الْإِنْذَارُ وَالدُّعَاءُ إِلَى التَّوْحِيدِ ، ثُمَّ فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ مَا ذَكَرَهُ فِي أَوَّلِ سُورَةِ الْمُزَّمِّلِ ، ثُمَّ نَسَخَهُ بِمَا فِي أَوَاخِرِهَا ، ثُمَّ نَسَخَهُ بِإِيجَابِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ بِمَكَّةَ بَعْدَ النُّبُوَّةِ بِعَشْرِ سِنِينَ وَثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ ، وَكَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَأْمُورًا بِالصَّلَاةِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ مُدَّةَ مَقَامِهِ بِمَكَّةَ وَبَعْدَ الْهِجْرَةِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
محاور فرعية
خدمات تفاعلية
اعدادات الخط
من فضلك اختار الخط المفضل لديك
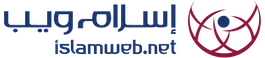
 المكتبة الإسلامية
المكتبة الإسلامية موسوعة التربية
موسوعة التربية كتاب الأمة
كتاب الأمة حول المكتبة
حول المكتبة قائمة الكتب
قائمة الكتب عرض موضوعي
عرض موضوعي تراجم الأعلام
تراجم الأعلام











 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات