[ ص: 382 ] النوع السابع عشر
المعرب في القرآن
ومعرفة ما فيه من غير لغة العرب
اعلم أن القرآن أنزله الله بلغة العرب ، فلا يجوز قراءته وتلاوته إلا بها ; لقوله تعالى : إنا أنزلناه قرآنا عربيا ( يوسف : 2 ) ، وقوله : ولو جعلناه قرآنا أعجميا الآية ( فصلت : 44 ) ، يدل على أنه ليس فيه غير العربي ; لأن الله تعالى جعله معجزة شاهدة لنبيه عليه الصلاة والسلام ، ودلالة قاطعة لصدقه ، وليتحدى العرب العرباء به ، ويحاضر البلغاء [ ص: 383 ] والفصحاء والشعراء بآياته ; فلو اشتمل على غير لغة العرب لم تكن له فائدة ; هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه ، وهو قول جمهور العلماء ، منهم : أبو عبيدة ، ومحمد بن جرير الطبري ، والقاضي أبو بكر بن الطيب في كتاب " التقريب " ، وأبو الحسين بن فارس اللغوي ، وغيرهم .
وقال الشافعي في " الرسالة " في باب البيان الخامس ما نصه : وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه لكان الإمساك أولى به ، فقال قائل منهم : إن في القرآن عربيا وأعجميا ، والقرآن يدل على أنه ليس في كتاب الله شيء إلا بلسان العرب ، ووجدنا قائل هذا القول من قبل ذلك منه تقليدا له وتركا للمسألة له عن حجته ، ومسألة غيره ممن خالفه ، وبالتقليد أغفل من أغفل منهم ، والله يغفر لنا ولهم " هذا كلامه .
وقال أبو عبيدة فيما حكاه ابن فارس : إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين ، فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول ، ومن زعم أن كذا بالنبطية فقد أكبر القول ، قال : ومعناه أتى بأمر عظيم ، وذلك أن القرآن لو كان فيه من غير لغة العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان بمثله ; لأنه أتى بلغات لا يعرفونها ، وفي ذلك ما فيه ، وإن كان كذلك فلا وجه لقول من يجيز القراءة في الصلاة بالفارسية ; لأنها ترجمة غير معجزة ، وإذا جاز ذلك لجازت الصلاة بكتب التفسير ، وهذا لا يقول به أحد . انتهى .
وممن نقل عنه جواز القراءة بالفارسية أبو حنيفة ، لكن صح رجوعه عن ذلك ، ومذهب ابن عباس وعكرمة وغيرهما أنه وقع في القرآن ما ليس من لغتهم .
[ ص: 384 ] فمن ذلك الطور ( الطور : 1 ) جبل بالسريانية .
( وطفقا ) ( الأعراف : 22 ) أي : قصدا بالرومية .
و ( القسط ) ( الأنعام : 152 ) ، و ( القسطاس ) ( الإسراء : 35 ) ، العدل بالرومية .
( إنا هدنا إليك ) ( الأعراف : 156 ) تبنا بالعبرانية .
و ( السجل ) ( الأنبياء : 104 ) بالفارسية .
و ( الرقيم ) ( الكهف : 9 ) : اللوح بالرومية .
و ( المهل ) ( الكهف : 29 ) عكر الزيت بلسان أهل المغرب .
و ( السندس ) ( الكهف : 31 ) : الرقيق من الستر بالهندية .
والـ ( إستبرق ) ( الكهف : 31 ) : الغليظ بالفارسية ، بحذف القاف .
( السري ) ( مريم : 24 ) : النهر الصغير باليونانية .
( طه ) ( طه : 1 ) أي : طأ يا رجل بالعبرانية .
( يصهر ) ( الحج : 20 ) : أي ينضح بلسان أهل المغرب .
[ ص: 385 ] ( سينين ) ( التين : 2 ) : الحسن بالنبطية .
( المشكاة ) ( النور : 35 ) الكوة بالحبشية ، وقيل : الزجاجة تسرج .
الـ ( دري ) ( النور : 35 ) المضيء بالحبشية .
ال ( الأليم ) ( البقرة : 10 ) المؤلم بالعبرانية .
( ناظرين إناه ) ( الأحزاب : 53 ) أي : نضجه بلسان أهل المغرب .
( الملة الآخرة ) ( ص : 7 ) أي : الأولى بالقبطية ، والقبط يسمون الآخرة الأولى ، والأولى الآخرة .
( وراءهم ملك ) ( الكهف : 79 ) أي : أمامهم .
( اليم ) ( الأعراف : 136 ) البحر بالقبطية .
( بطائنها ) ( الرحمن : 54 ) : ظواهرها ، بالقبطية .
( الأب ) ( عبس : 31 ) : الحشيش بلغة أهل المغرب .
( إن ناشئة الليل ) ( المزمل : 6 ) قال ابن عباس : نشأ بلغة الحبشة : قام من الليل .
( كفلين من رحمته ) ( الحديد : 28 ) : قال أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - : ضعفين بلغة الحبشة .
[ ص: 386 ] ( القسورة ) ( المدثر : 51 ) : الأسد بلغة الحبشة .
واختار الزمخشري أن التوراة والإنجيل ( آل عمران : 3 ) أعجميان ، ورجح ذلك بقراءة " الأنجيل " بالفتح ، ثم اختلفوا فقال الطبري : هذه الأمثلة المنسوبة إلى سائر اللغات إنما اتفق فيها أن تتوارد اللغات ، فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة بلفظ واحد ، وحكاه ابن فارس عن أبي عبيد .
وقال ابن عطية : " بل كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلغتهم بعض مخالطة لسائر الألسنة بتجارات ، وبرحلتي قريش ، وكسفر مسافر بن أبي عمرو إلى الشام ، وسفر عمر بن الخطاب ، وكسفر عمرو بن العاص ، وعمارة بن الوليد إلى أرض الحبشة ، وكسفر الأعشى إلى الحيرة وصحبته مع كونه حجة في اللغة ، فعلقت العرب بهذا كله ألفاظا أعجمية غيرت بعضها بالنقص من حروفها وجرت في تخفيف ثقل العجمة ، واستعملتها في أشعارها ومحاوراتها حتى جرت مجرى العربي الفصيح ، ووقع بها البيان ، وعلى هذا الحد نزل بها القرآن ، فإن جهلها عربي فكجهله الصريح بما في لغة غيره ، وكما لم يعرف ابن عباس معنى فاطر إلى غير ذلك .
قال : فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها في الأصل أعجمية ، لكن استعملتها العرب وعربتها ، فهي عربية بهذا الوجه .
[ ص: 387 ] قال : وما ذهب إليه الطبري من أن اللغتين اتفقتا في لفظه فذلك بعيد ، بل إحداهما أصل والأخرى فرع في الأكثر ; لأنا لا ندفع أيضا جواز الاتفاقات إلا قليلا شاذا .
وقال القاضي أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك : " إنما وجدت هذه في كلام العرب ; لأنها أوسع اللغات وأكثرها ألفاظا ، ويجوز أن يكون العرب قد سبقها غيرهم إلى هذه الألفاظ ، وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مبعوث إلى كافة الخلق ، قال تعالى : وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ( إبراهيم : 4 ) .
وحكى ابن فارس عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه حكى الخلاف في ذلك ، ونسب القول بوقوعه إلى الفقهاء ، والمنع إلى أهل العربية ، ثم قال أبو عبيد : والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعا ، وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء ، إلا أنها سقطت إلى العرب فعربتها بألسنتها ، وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية ، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب ، فمن قال : إنها عربية فهو صادق ، ومن قال : أعجمية فصادق . قال : وإنما فسرنا هذا لئلا يقدم أحد على الفقهاء ، فينسبهم إلى الجهل ، ويتوهم عليهم أنهم أقدموا على كتاب الله بغير ما أراده ، فهم كانوا أعلم بالتأويل ، وأشد تعظيما للقرآن .
قال ابن فارس : وليس كل من خالف قائلا في مقالته ينسبه إلى الجهل ، فقد اختلف الصدر الأول في تأويل القرآن .
قال : فالقول إذن ما قاله أبو عبيد ، وإن كان قوم من الأوائل قد ذهبوا إلى غيره .
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
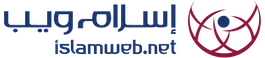
 المكتبة الإسلامية
المكتبة الإسلامية موسوعة التربية
موسوعة التربية كتاب الأمة
كتاب الأمة حول المكتبة
حول المكتبة قائمة الكتب
قائمة الكتب عرض موضوعي
عرض موضوعي تراجم الأعلام
تراجم الأعلام














 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات